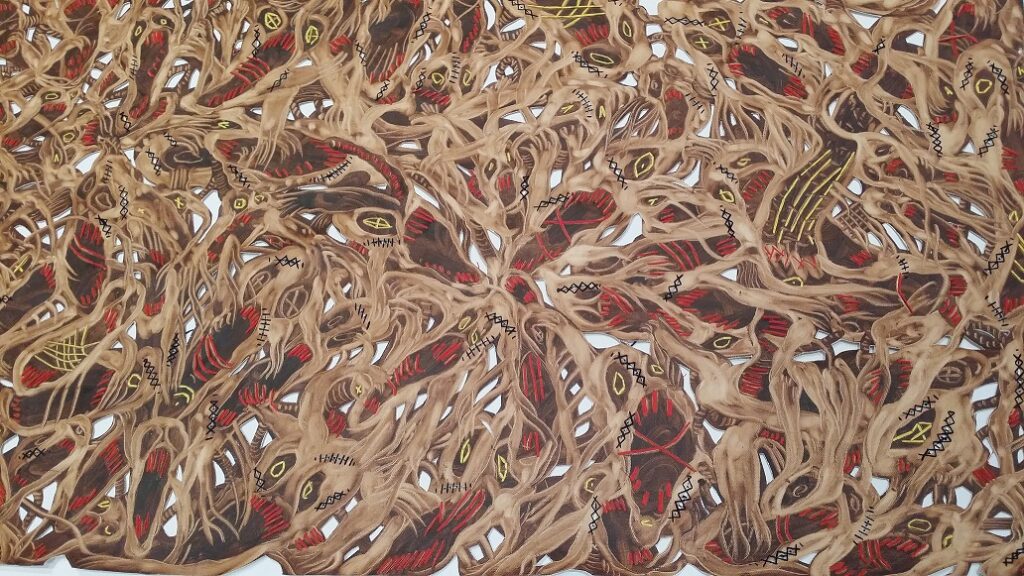
لحظة الاستثناء: الاستثناء انعطاف حاد عن مسار مشترك. صدمة تعيد الدهشة للمألوف وتكسر الجمود. ما إن أقول: “كلّهم إلا أنا”؛ فأنا أشير إلى شيء يتمرّد على سياق. هذا يستدعي في الأصل وجود مشترك يصنع رابطة قديمة يُراد كسرها بالاستثناء. ذلك المشترك هو وحده ما يعطي المعنى للمستثنى. لا معنى لهذه الجملة لو فصلت الأنا عن الكلّهم تماما. الاعتيادي هو الصهارة التي تذيب كل الاختلافات. المستثنى يبتعد كلما حاول الاعتيادي تطويقه. عند الاستثناء تبدأ عتبة الانقسام. أنا حالة خاصة، أو نحن لنا خصوصيتنا؛ كلتا العبارتين تدشنان عنوانا جديدا يحاول الانفصال عن عنوان قديم. أنت مختلف، أنت لست غيرك؛ هنا تبدأ الذات تكتشف نفسها. يبدأ الوجود مع الاستثناء. الأصل ينبت فرعا جديدا، والفرع يحاول تخليص نفسه لكي لا يقع في معضلة الاعتيادي. لهذا كلنا نريد أن نكون استثنائيين؛ نريد أن ننسى الرابطة مع الاعتيادي. حتى لو كان نسيانها التام سيدخلنا في العبث والعدم. الاستثناء يخلق توترا وارتباكا بين السائد والمستثنى. تظل الهزّات تتكرر بينهما، فإما أن تزول الفوارق والتمايزات، أو يصبح الصراع أبديا. حالة الشدّ والجذب بين الاعتيادي والاستثنائي هي نواة الاستثناء. وما إن تنتهي وتتلاشى حتى يفقد المستثنى بريقه. الاستثناء يدخل في ظواهر كثيرة جدا؛ اجتماعية أو طبيعية أو نفسية. القومية والعنصرية والتفوّق والطبقية والاحتلالات والتطوّر والأنانية والابداع؛ كلها إفرازات لأشكال متراكمة من الاستثناء.
الولادة الثانية: غالبا ما تكون ما نسميه ب “الولادة الثانية”؛ هي إعادة ترميم لعلاقة متكسّرة بين الذات والموضوع. يعني كانت هناك علاقة جبرية بين الإنسان وأشياء هذا العالم (معتقدات، ممتلكات، صداقات، علاقات حب)، وهذه العلاقة القهرية تكشف نفسها كموضوعات مفروضة فرضا على الذات. ما إن يبدأ الإنسان في الإحساس بثقل هذه الأشياء عليه؛ حتى يبدأ في الدخول إلى مرحلة من التكسّر والحطام (وربما العدمية)، بحيث لا يكاد يستطيع إيجاد نفسه داخل معمعة هذه الأشياء والموضوعات التي تمزّقه وتقطّعه إلى عدّة ذوات متصارعة داخله. تأتي الولادة الثانية كلحظة خلاص من ذلك الضياع والتيه والتمزّق. جوهر هذه الولادة ولبّها هو الحرية في العلاقة بين الذات وموضوعاتها. بمجرد ما ينجح الإنسان في اكتشاف وتذوّق هذه الحرية، وتحويلها إلى نمط حياة؛ يكون قد أعاد ولادة نفسه، ودخل في مرحلة سلام مع الموضوعات القديمة. لا يعود المعتقد القديم مثلا قهريا؛ بل هناك حالة حرية بين الإنسان ومعتقداته السابقة. وكذا مع علاقة حب قديمة، أو مع منصب ومكانة قديمة. المهم أن الحرية دخلت على الخط لتصنع اتحادا فريدا بين الذات والموضوع. لهذا كل من يتحدث عن ولادته الثانية؛ فالأرجح أنه يتكلم عن شعور بالحرية جاء كبلسم للجراح التي يتسبب بها الجبر والقهر.
التواضع في الوعي: يمكن لمفردة “الوعي الكلي” أن تعني تلك القابلية على إلقاء نظرة واسعة على الواقع، وتضمين عدد كبير من المتغيرات بما يصنع إدراكا وفهما شاملا للتناقضات والعلاقات بين هذه المتغيرات (الأفكار، البشر، المؤسسات، المعايير). هكذا شخص يمتلك وعيا كليّا يذيب فيه أكبر قدر من الروابط؛ سيكون أقدر على معرفة ما يجري في حقيقة الأمر، وغالبا ينتبه إلى ما لا ينتبه إليه الآخرون من دوافع ومبررات وغايات تصنع التدافع البشري والصراعات الاجتماعية. فالشخص صاحب الوعي الكلي؛ يحاول أن يجعل من موقفه لا يُغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وضعها بعين الاعتبار، لهذا فمقاومة رأيه واكتشاف الخلل فيه ليس بالأمر السهل؛ بسبب شمولية رأيه والمدى الواسع الذي يراه. تبقى المشكلة مع هذا الإنسان صاحب الوعي الكلّي أنه يكون أكثر بطئا في الحركة كلما اتسع وعيه وضمّن متناقضات أكثر. حذره يزيد، ويتأخّر في مواقفه، وغالبا ما يكون مثبِّطا ومحبَطا في نفسه، بحيث يصبح وعيه عالة عليه. فقد يكون الشاب الغرّ الذي ما يزال في مقتبل عمره، وحجم ما يدركه من الحياة متواضع جدا أمام وعي هذا الخبير صاحب الوعي الواسع؛ إلا أن هذا الشاب يكون أنفع لنفسه ولواقعه باندفاعه في رفع الظلم وسعيه الغريزي لجعل الحياة أفضل. ففي المقابلة بين الوعي الواسع وبين الوعي الضيّق لا نستطيع أن نصنع مفاضلة حقيقية في تحويل الوعي إلى برامج ومؤسسات وفعاليات. لا بدّ إذن من أمر آخر إضافي يجب أن يُضاف للوعي الكلي؛ ليجعله وعيا عمليا يمكن أن يتحرّك بفاعلية وخفّة. أكاد أن أرى هذا الأمر في “التواضع”، وفي النسيان اللحظي لهذا الوعي الشامل، لصالح أشكال إجرائية من الوعي. بمعنى أنه لا بدّ وفي لحظة معينة أن نقاوم ذواتنا العارفة، ونقنعها بأنها جاهلة، لكي تتخذ موقفا عمليا يتوازى مع سرعة تدفّق الأحداث. فالوعي الشامل لا يكفي لصنع الإنسان الناضج؛ ما ينقصه هو البراءة التي تجعله يبدو يافعا كثير الأخطاء بالرغم من خبرته الطويلة. باختصار؛ الانتقال من الوعي الكلي إلى الوعي العملي.
الدهشة في التواضع: هناك صلة عجيبة بين التواضع والدهشة. بطريقة ما؛ إذا كان ما نسميه تواضع لا يقود إلى دهشة ما، فالأرجح أنه ليس تواضعا! أي شيء آخر غير التواضع! صفقة مخفية، فخّ، ذلّة واتّضاع؛ ربما. التواضع الذي يؤدي إلى الدهشة؛ شيء يشبه تواضع الأطفال عندما يسألون. لا يخطر في بالهم أنهم يفضحون جهلهم، بل بالعكس؛ يشعرون بلذّة عجيبة عندما يطمئنون إلى أن الكبار يمتلكون إجابات هم لا يمتلكونها. هذا التواضع هو نوع من الثقة المستعدة لإلغاء نفسها في أي لحظة. وبدون ذلك لا يشعر الإنسان بأي رغبة في تعلّم الجديد؛ لأنه حاز على الحقيقة التي يريدها أو يكاد. هذا التواضع شرط أساسي لدى كل من يطلب العلم، فبدونه لا يمكن أن يدهشك العلم بأجوبته. طبعا ليس تواضع الأدب والأخلاق ما أقصده هنا، فهذا التواضع من قبيل الاعدادات الافتراضية. ولكن ما يأتي بعد ذلك. هل يوجد شيء غير طبيعي في التواضع؟ هل الثقة تصنع تزمّتا في الفكر؟ الاستعداد للتغير مرتبط بهذا النوع من التواضع الملتبس بالدهشة.
الخلق الأول: من بين الكثيرين الذي يحيطون بنا؛ لا بدّ وأن نصادف أشخاصا ما زالوا على فطرتهم التي أنبتتها ظروفهم الطبيعية التي نشأوا فيها، فلم ينخرطوا في أي مشاريع إضافية عدا تلك التي تولّدت بشكل عفوي من رغباتهم الطبيعية. بمعنى لم يتبنوا قضايا أو مشاريع زائدة على حاجتهم، وكانت البرمجة التي خضعوا لها بطفولتهم أو شبابهم في مستواها الأدنى. شخصيا أثق بحدس هؤلاء أكثر من ثقتي بحدسي. بل أكثر من ذلك؛ أستطيع أن أعتبرهم المرآة التي أريد أن ألج عن طريقهم إلى أعماقي. هم مدهشون بملاحظاتهم التي تتولّد عفويا قبل أن توجّهها المشاريع والأيديولوجيات. هؤلاء ليسوا نادرين، بل على العكس؛ كثيرون بيننا. فقط، نحتاج إلى تصفية الذهن للوصول إليهم.
الأنا البعيدة: هل لديك رغبة في أن تكون مؤثرا في الواقع؟ هل لديك هاجس بذلك؟ هل يحركك ذلك للفعل الاجتماعي؟ أم أنك تعيش ذاتيّة خالصة أو تكاد في نشاطاتك المختلفة (تلبية دعوات، كتابة، فعاليات، تبليغ، حوارات، …)؟ بصياغة أخرى: هل تحب أن تكون محاطا بأكبر عدد من الأصدقاء والمهتمين؟ هل يشغلك أن ترى أثرا منك في الآخرين؟ هل الإقناع لديك شكل للتمدد والانتشار أم فقط إلقاء حجة؟ هل يدور في عمقك فكرة أن تكون في يوم ما قطبا (بالمعنى الصوفي)؟ هل تستطيع فعلا التفكير ولو للحظة أن تعيش وجودك كشيء مرميٍّ لا ضرورة له وفي نفس الوقت تتحرك هنا وهناك؟ باختصار؛ هل تستطيع أن تستغني عن نفسك؟ لا أظنّ ذلك. ولكن لعلّ من الأفضل أن تكون أنواتنا بعيدة. بعيدة جدا. السؤال هنا سيصبح عن ذلك الشيء الذي يجعلنا دائما مشغولين بالأبعد منا! ما إن تستقر بمكان معين أو بلحظة زمنية ما حتى لا يعود فكرك مشغول سوى بما هو أبعد من ذلك المكان أو تلك اللحظة! أكثر من ذلك؛ عندما يصبح نفس ما كنا نطلبه بالأمس، لم يعد كذلك عندما وصلنا إليه. السؤال سيكون: ما هو هذا الذي يريد التمدد في كل الاتجاهات، ويريد احتواء الكون كله وضمّه إلى مملكته؟ الشاعر يفعل ذلك، والموسيقيّ يفعل ذلك أيضا. العالِم في مختبره والرياضيّ في رياضته والمتعبّد في محرابه؛ جميعهم يطلبون الأبعد. حتى الطفل. ويبدو أنه حتى بعض الحيوانات كذلك. ما الذي نريده من ذلك البعيد؟ من أين يأتي كل هذا الفضول؟ ولماذا تحديدا في تلك اللحظة؛ يصبح الفيزيائي موسيقيا، والفقيه صوفيا، والفيلسوف شاعرا، والطفل مبدعا؟ تلك هي الأنا البعيدة.
تذمّر الرضا: من أعقد حالات الشعور الانساني؛ حالة الرضا في التذمّر والتذمّر في الرضا. شيء يشبه أن يشتكي الواحد من الفقر وفي نفس الوقت يسبّح بحمد من تسبّب في فقره. هناك ثقة عجيبة؛ مُفتعلة بفعل فاعل على الأرجح؛ هي ما تنتج هكذا شعور. ثقة بأن العدالة موجودة في مكان ما؛ وستأتي بنفسها قريبا. يشتبك هنا الخوف والرجاء بطريقة فجّة تجعل الإنسان في أقصى حالات البعد عن الواقع. عالم مُفترض موازي سيتعطّف فيه صاحب المال أو المعرفة أو السلطة على هذا البائس فيتفضّل عليه برفع مستوى معيشته. الرضا في التذمّر والتذمّر في الرضا؛ من أسوأ أشكال العجز. فقدان تام للقدرة على الفعل في ظل إمكانيات كبيرة على الفعل. شلل مدمّر يقذف بالروح في محيط واسع من الازدواجيات. الأرجح أن الخلاص يكمن في إدراك أن الفارق بين القوّة المطلقة والضعف المطلق هو فارق وهمي. داخل كل قوة يوجد ضعف؛ يتجلّى أكثر كلما تفرعنت القوة أكثر، وداخل كل ضعف توجد قوة؛ تتجلّى أكثر مع تعمّق الضعف أكثر.
الصمت كنصيحة: من أسهل الأشياء في الحياة؛ أن ينصح الشخصُ الناجح الشخصَ الفاشل. بعيدا عن معايير النجاح والفشل التي هي في الأصل ليست مؤكّدة؛ وربما مُتوهّمة، ولكن لو اعتبرنا النجاح كقناعة داخلية، فهذا يصنع شخصية تشعر بالتفوّق على الغير، أو أنها أعلى من المتوسط، وبالتالي تستطيع أن تفيض على جوانبها على شكل حكمة مزعومة. حسنا.. إلى هذا الحد الوضع عادي. ولكن هناك لحظات أبعد من كل ذلك تستحق التجربة. وهي ما يمكن أن أسميه: الجوع المطلق للنجاح، والشبع المطلق من الفشل. في اللحظتين؛ يوجد ثراء داخلي يجعل الإنسان في القمة والقاع في نفس الوقت. روح قويّة من قوّتها انها ليس لديها أدنى رغبة في استنساخ نفسها، وفي نفس الوقت لا يخالجها أدنى شك بأن ما ينقصها يمكن أن يكون موجودا خارجها. هؤلاء هم ملح الحياة. الصامتون الذي يسخرون من كل النصائح؛ فقط لأن النجاح والفشل من صدف الحياة المضحكة.
الإصلاح وتكامل النفس: لا يجدر بصاحب أي مشروع إصلاحي أن يقرأ نفسه كمصلح. أو على أقل تقدير؛ أن لا يقدم نفسه كمصحح لسلوك وأفكار الآخرين. هذا لا يعني أن لا يفعل شيئا؛ بل فقط أن يحرّر نفسه من أن الآخرين يحتاجون إليه. فقط في تلك اللحظة ستبدأ عملية الإصلاح المؤثرة والفاعلة. يعني في اللحظة التي يبدأ فيها في سبر أغوار نفسه؛ في اكتشاف مساحات الفراغ بين ما يعتمل داخله وبين ما يلاحظه في الواقع اليومي. إكمال النقوصات الكثيرة هي عملية تفاعلية في نفس الوقت، نقص الداخل والخارج في نفس الوقت. ليس لديّ أكثر مما لديكم؛ حتى لو كان الداخل أكمل من الخارج. لأن نقصا واحدا لديّ يعادل في خطورته وأهميته عشرات النقوصات في الخارج. أن أجهل شيئا واحدا أسوأ بكثير من أن يجهل الآخر عشرة أشياء. وخصوصا في هذا العصر المتسارع والمليء بفرص تحصيل المعرفة واكتشاف المجهولات. وهكذا عندما نفتح الحوارات البينية؛ فيعني أننا نريد أن نكتمل بالآخرين تماما كما نظن أن الآخرين يكتملون بنا. هذا يجعلني اراجع نفسي وانا صدّرت هذا المنشور بكلمة “لا”! هل كنت فيها؛ أفتح أم أغلق بابا؟
سياسة الدفع إلى الحافة: في الحالات التي تهتز فيها ثقتك بأحد معتقداتك السابقة؛ من الوارد جدا أن تتوصّل إلى صيغة أخلاقية معيّنة تخفّف من أهمية هذا المعتقد وحدّيّته، وفي نفس الوقت لا تصطدم به، إذ ما يزال يقنع الكثيرين ممّن يهمونك. كل ذلك من أجل أن تحافظ على اتّزانك النفسي والعاطفي، وربما موقعك الاجتماعي. غير أنك ستصادف كثيرا أشخاصا يحاولون أن يدفعونك دفعا نحو الحافة؛ نحو أبعد مدى ممكن لرفض هذا المعتقد وما يجاوره من معتقدات متّصلة. سياسة الدفع إلى الحافة ممكن أن تأتي من أنصار المعتقد؛ وذلك لإبعاد أي تصورات تحاول تمييع حدود الحقيقة التي يحملها المعتقد، كما يمكن أن تأتي من رافضين مخضرمين لهذا المعتقد؛ وأيضا لحماية الحقيقة المفترضة والتي يحملها نقيض المعتقد. لكل واحد منا سقف من التوقعّات والمواهب والإمكانات، ودائما ما تكون صيغنا الأخلاقية مرتبطة بهذا السقف. فمن يدفعك نحو الحافة؛ لا يستطيع تصوّر مشروعية موقفك الأخلاقي النابع مما تستطيع فعلا أن تقوم به. جدل الحقيقة في أغلب الأحيان يخفي ما هو أبعد وأعمق، وهو البحث عمّن يشبهنا وإبعاد من ليس كذلك. ومع الوعي بأن الحوافّ لا تنتهي، فالأرجح أن أي استجابة غير متأنيّة لسياسة الدفع نحو الحافة؛ ستنتهي بك شخصا تافها لا يستطيع تعريف الحقيقة التي يحرّكها لاعبون متمرّسون. وهكذا فأفضل استجابة لسياسة الدفع نحو الحافة هي في هندسة الصيغة الأخلاقية الأكثر توافقا مع واقعك، وليس الاندفاع الأعمى نحو خطابات الحقيقة المتناسلة.
أنا خفيفة: لا أملك شيئا. لا شيء ينتمي إليّ. الملكية قضية قهرية. يجب أن نمتلك شيئا ما لكي نكون أعضاء في جماعة ما. ندخل بيد فارغة. سنخرج بيد فارغة. وما بينهما خدعة كبيرة اسمها الأنا. لا يمكن أن تكون هناك جماعة بدون وجود الأنوات. الفردانية وهم مؤقت؛ يتلاشى عند أوّل اعتراض. الفردانية وقود الحياة. الحياة إعادة تدوير للكائنات الحية. الدي إن إيه في الأصل هو تمرّد على الامتلاك. هو نتيجة الروابط القهرية للكيمياء القديمة. هل الحل في نزع الملكية؟ أبدا. نزع الملكية هو ملكية أخرى. ماذا تبقى؟ بقي العبور الخفيف. الحد الأدنى من كل شيء. من الحرية، من الحب، من الاشياء، ومن الأقنعة.
استئناف البدايات: هل أنت من النوع الذي يحب أن ينسى انجازاته السابقة ويفضل دائما أن يبدأ من جديد؟ حسنا.. سأفترض مقدما أن أحدا ينسى ما يعتبره نجاحاته؛ غير موجود أساسا. ولكن لأن الناس ينسون؛ فيجب أن ننسى نحن أيضا، لئلّا نمتلئ بالحسرة. حتى لو كانت لهذه الحسرة حسنات أحيانا. هناك منطقة عميقة في الشعور الانساني تجعله متّصلا على الدوام، فالفرق بين أول انجاز يصفّق له الأبوان فقط، وآخر انجاز يصفّق له العالَم كلّه؛ هو فرق في الترتيب الزمني فقط. تلك المنطقة العميقة مهمة جدا في تثوير الهمّة دائما لصنع شيء جديد. قد لا نحسن الاتصال بذلك الشعور الغائر، فنظّنه بدايةً ما هو إلا أنانية تجعلك تفرض نفسك على الحياة، ولكن قليل من الجمال تتذوقه في كل صباح يجعلك تعيد التفكير في أنّك شخص مهمّ لأحد ما في هذا العالم، مهم للدرجة التي تفتعل متعمدا طارئيتك (غير ضروري). بل ومهم حتى بعد موتك. فتندفع من جديد لملء رئتيك بالأكسجين وتحيّة حتى عمّال النظافة في الشوارع اللاهبة. تلك المنطقة العميقة هي نواة الموت والعدم. الرحيل اللاإرادي أو الرقصة الأخيرة مع الموت.
Views: 734